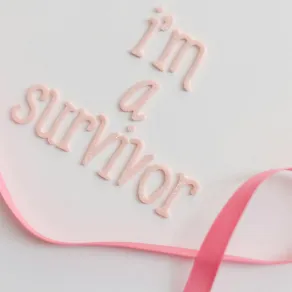لا أدري ما الذي خطر في بالي لحظتها. لا أعرف حقاً. سمعت ما قالته لي وأشرت برأسي موافقة.. «نعم مدام.. لا مشكلة لدي...»،
للمرة الثانية أقبل ما تعرضه عليّ. ولا أندم.
أعرف أن الأمر لو طرح على شخص آخر لأجفل، ولربما رفض على الفور، أو على الأقل طلب مهلة للتفكير.
أنا لم أحتج لذلك. مدام مادلين هي الشخص الوحيد القريب مني. الشخص الوحيد الذي أشعر بأنه يقلق عليَّ عندما أمرض، ويسأل عني عندما أغيب، ويهتم لمعرفة ما يدور في رأسي، ما أفكر فيه، وما أرغب به. المسافة الاجتماعية بيننا شاسعة رغم ذلك. هي... موظفة السفارة المحالة على المعاش، صاحبة الفيلا الفخمة والسيارة الأنيقة ورصيد البنك الثقيل والامتيازات الاجتماعية الكثيرة... وأنا... أنا خادمتها المقطوعة من شجرة... لا أعرف لي أهلاً ولا أصحاباً...
أرعى شؤون بيتها وأجيب طلباتها منذ سبع سنين.
حين أعلمها الأطباء بأن آلام رأسها المزمنة ناتجة عن ورم خبيث لا تنفع إزالته، عادت إلى البيت تبكي وترتجف وتتساءل كيف ستتحمل آلامها؟ وماذا تصنع بانتظار ساعة خلاصها؟ وكيف ترحل عن هذه الدنيا دون أن تخلف ولداً ولا أسرة تنعاها وتتأثر لغيابها؟!
جالستها يومها طويلاً، وفي وقت متأخر من الليل قالت لي إنها قررت السفر لوجهة طالما فكرت فيها يوم أن كانت تتمتع بصحتها. وسألتني إن كنت مستعدة لمرافقتها. وقبلت دون تفكير.
زيارتنا الأخيرة لأطبائها لم تكن طيبة. طلبت أن أرافقها ولم أمانع. الأطباء الثلاثة استقبلونا بحرج بالغ. حاولوا رفع معنوياتها كيفما استطاعوا، ورحبوا بفكرة السفر، لكنهم وجموا عندما أصرت على أن تعرف كم تبقى لها تقريباً قبل ساعة الرحيل.
ثلاثة أشهر أو أقل قليلاً. الورم مستفحل والأجل بإذن الله في النهاية.
غادرنا إلى الوجهة التي اختارتها. كينيا. بلد لا أعرف عنه شيئاً على الإطلاق.
مدام مادلين قضت فترة عمل هناك في الثمانينات على ما أخبرتني. التحاقها بسفارات بلدها مكّنها من التنقل بين قارات العالم الخمس. لكن كينيا بقيت في قلبها. حلمت كثيراً بالقيام برحلة سفاري هناك، ولم تمكنها الظروف من ذلك.
اختارت أن نستقر فترة في أحد أكبر فنادق نيروبي. موفنبيك. أرعبتني فخامة المكان، وحاولت أن أثنيها عن حجز الجناح الذي أعجبها، لكنها ردت بانفعال: «أمامي أقل من ثلاثة أشهر يا سارة. دعيني أصرف الأموال المكدسة في حسابي كما أرغب. لا يمكنني أخذها معي هناك، أليس كذلك؟».
اضطربت... وتركتها تتصرف كما تريد.
قضينا أياماً في التجول في العاصمة وترتيب رحلة السفاري التي جئنا لها. رحلة طويلة وشاقة في محمية وطنية تدعى «ماساي مارا». لم نكن وحدنا. رافقنا شخصان خلال جولاتنا في ميني باص أخذنا لمتابعة قوافل الفيلة وتجمعات الأسود والفهود وقطعان الزرافات والجواميس ومختلف الحيوانات البرية. طفنا أيضاً بالمنطاد فوق الغابات والأحراش والسافانا، وراقبنا قطعان فرس النهر العائمة وطيور النحام الوردية والبجع الأبيض، وانبهرنا بمنظر غروب الشمس الأسطوري خلف السهول والمرتفعات المغطاة بالأشجار البرية.
لم نعد نتحدث عن شيء آخر غير سكون الطبيعة وجمال الحياة بعيداً عن المدن.
قررت مدام مادلين أن نجول طويلاً هناك. لم نجد مشكلة في تمديد أوراق إقامتنا. مدام مادلين احتفظت بعلاقات وثيقة بالسفارة الفرنسية هناك حيث كانت تعمل. جلنا البلد بالطول والعرض، قابلنا الكثير من الناس، نمنا لدى قبائل الماساي المعروفين بتقاليدهم الراسخة في المناطق البرية، أكلنا أكلهم وتواصلنا بشكل أو بآخر معهم، تهنا بين الجبال والغابات والبحيرات، وذات ليلة قضيناها في العراء، في طريقنا إلى قرية قيل لنا إنها تقع قرب غابات تزخر بأنواع من الطيور الزاهية التي لا يوجد لها مثيل في مكان آخر على الأرض، سألتني مدام مادلين.. كم مضى علينا من الوقت ونحن في هذا البلد؟ «أربعة أشهر تقريباً...»، أجبتها وحبست أنفاسي وأنا أنظر إليها، وهي تنظر إليَّ.
أكثر من المدة التي قال الأطباء إن المرض يمنحها لها قبل أن... ترحل.
حملقت فيها. لم تبد لي يوماً بصحة جيدة وبعافية واضحة كما الآن. وجهها مشرق. عيناها يقظتان. وجسدها في أفضل حال.
«والصداع... لم أعد أشعر بالصداع...».
أخذتها في حضني ونحن نبكي معاً. وهمست لي: «لن أغادر هذا البلد. لن أكف عن التجوال في البرية. هل تبقين معي؟».
«نعم. سأبقى معك. لا مشكلة لديّ مدام».
قلت دون تفكير.
للمرة الثانية، قررت في رمشة عين أن أندفع مع السيدة التي فتحت لي قلبها في مغامرتها البرية دون تفكير.