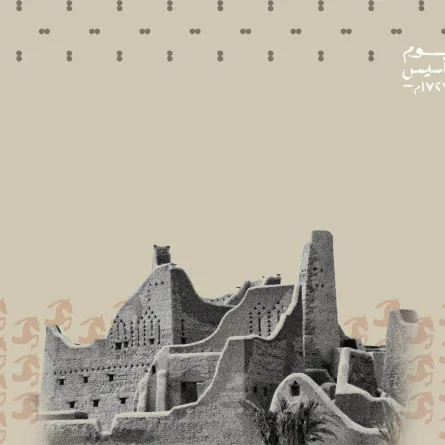بصوت الندم والحسرة، تكلمت الأم عن تجربتها قائلة:هو وحيدي الذي انتظرته أكثر من عشر سنوات بعد عديد من التجارب والفحوصات، وبوصوله عشت القلق والحيرة معه وعليه معظم الأوقات؛ كنت أخشى عليه الهواء الطائر والنسمة العابرة.
أقمت حوله حصاراً وسياجاً من الخوف والحذر، كل طلباته أوامر، مالنا ووقتنا أنا وزوجي لخدمته ومراعاته، أدخلناه أعظم المدارس، وجلبنا له الأساتذة بالبيت ليتابعوه، وأقولها سراً: كنت أتصارع في الخفاء وبطرق لا واعية لأحصل على مزيد من حب طفلي..حتى أتفاخر بالتصاقه وارتباطه بى أمام والده والناس.
وحدة
تتابع الأم: "مرت السنوات حلوة جميلة، سعدنا به وأمتعنا، وما أن أتم العاشرة إلا وأصبح طفلاً جديداً؛ متمرداً ورافضاً كل ما نقوله ونفعله من أجله، يأتي من مدرسته حزينا مكتئبا؛ فهو غير قادر على الاتصال، وليس له أصحاب، لتتوالى المشاكل يوماً بعد يوم، وكأن صغيري خرج من قمقمه ليواجه حياة لا يعرفها وسلوكيات لم يتعود عليها!
المعلمون يشتكون من أنانيته وحبه لذاته وعدم قدرته على الاعتماد على نفسه، زملاؤه في المدرسة يضايقهم حبه للسيطرة والتملك أو الخجل والانطواء فالانسحاب، وبين يوم وليلة تحول الحب بداخلي إلى مشاعر محملة بالخوف والذعر على مستقبل صغيري!
بعدها قررت وعزمت الذهاب إلى طبيب نفسي، ومعه حكيت واستفضت:
- لم نبخل عليه بالحب والرعاية والمال
- ليصبح المحور الوحيد في حياتنا
- ضحينا بالكثير ولم ننشغل عنه
- لم نشعره يوما بأنه فرد ثالث في الأسرة له كيانه واستقلاليته، بعيدا عن لغة التدليل والاستحواذ.
تابعت الحوار والعلاج مع الطبيب لأسابيع، ومثلما جاهدنا – أنا وزوجي- لنعطي وحيدنا الحب والحنان، تشاركنا في إصلاح ما فعلناه؛ وكان لنا خطوات معه.
أولاً: تعمدنا ألا نلبي كل طلباته.
ثانياً: رمينا عليه ببعض المسؤوليات ليتعود الاعتماد على نفسه.
ثالثاً:عاملناه بشكل طبيعي دون تدليل زائد أو قسوة مُفتعلة وأحطناه بجو اجتماعي أسرى ليتأقلم على التعامل والتواصل مع الآخرين، وكنا كمن يُحاول إصلاح ما كسره!
رابعاً: تركناه فترات ليعيش عالمه الصغير بغرفته مع لعبه وهواياته بعد إن كان ملازماً لعالم الكبار.
خامساً: و لم أعد أسمح له بحرية الخطأ دون عقاب، ولم أفرض عليه نوعية الأصدقاء.
سادساً: علمته كيف يكون الأخذ والعطاء لينمو بشكل صحي وسط الناس...وكم كانت فرحتي -أقصد فرحتنا- باستجابة صغيرنا ووحيدنا للعلاج.