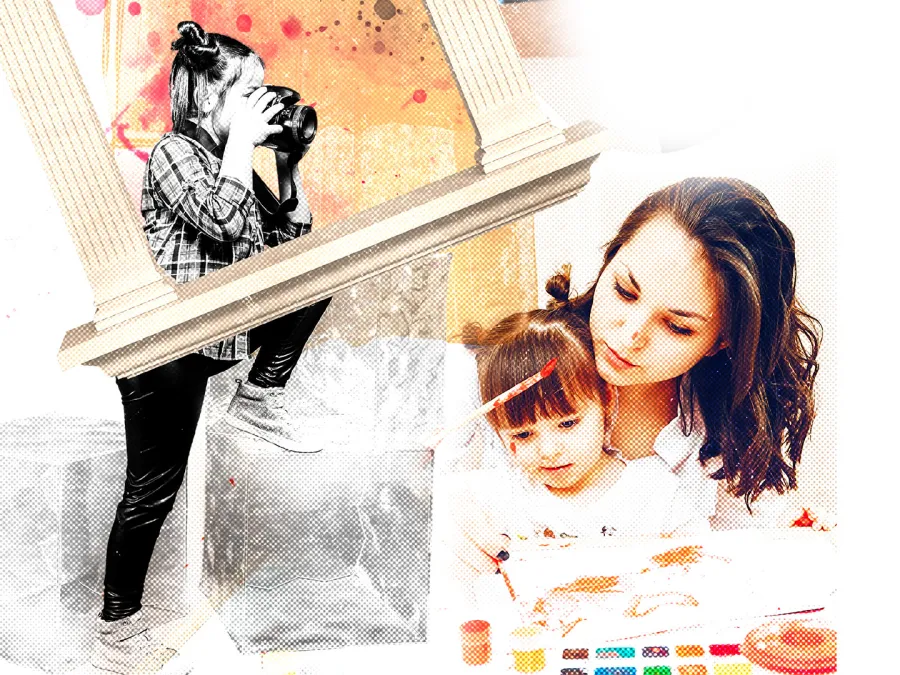في عالمٍ تتسارعُ فيه التكنولوجيا، وتتعدَّدُ مصادرُ الإلهاء، تبرزُ أهميَّةُ تنميةِ الحسِّ الفنِّي، والجانبِ الإبداعي لدى الطفل بوصفه عنصراً حيوياً في تشكيلِ شخصيَّةٍ متوازنةٍ، ومرنةٍ، وذات قدرةٍ عاليةٍ على التعبيرِ عن النفس، إذ إن الفنَّ، يتجاوزُ كونه مجرَّد هوايةٍ فقط، فهو أيضاً لغةٌ داخليَّةٌ، تعكسُ عالمَ الطفلِ النفسي، ما يُشكِّل وسيلةً فاعلةً لفهمِ مشاعره، وتوسيعِ آفاقِ تفكيره، وتحفيزِ قدراته الذهنيَّة. في هذا اللقاءِ مع المربِّيةِ والمدرِّبةِ الوالديَّةِ المعتمدة نجوى كبَّارة، نتناولُ طرقَ تنميةِ الذوقِ الفنِّي والإبداعِ عند الأطفال، وأثرِ زيارةِ المتاحفِ في الحفاظِ على ذاكرتنا الثقافيَّةِ المشتركة، كما نتطرَّقُ إلى دورِ الأهلِ في هذه العمليَّة.
الفن أداة تربوية عميقة

نجوى كبَّارة، هي أيضاً باحثةٌ في علمِ الأعصاب والصحَّةِ النفسيَّة، وتحملُ خبرةً، تمتدُّ لأكثر من 18 عاماً في التعليمِ، وإدارةِ المدارس. أسَّست منصَّةَ «دائرة الثقة» The Circle of Trust لخدمةِ العائلاتِ العربيَّةِ عبر برامجَ مبنيَّةٍ على التكاملِ بين العلمِ الحديث والسياقِ المحلي لكسرِ أنماطِ الانفعاليَّة، وترسيخِ الحضورِ والتعاطف، وإيضاحِ القيم، والتواصلِ الواعي داخل الأسرة، كما تتعاونُ مع مدارسَ ومؤسَّساتٍ لدمجِ مهاراتِ التنظيمِ العصبي داخل الصفوفِ والبيوت، وإعادةِ صياغةِ الأنماطِ التربويَّة، وتحويلِ بيئةِ المنازلِ والمدارسِ إلى بيئةٍ آمنةٍ، يزدهر فيها الأطفالُ معرفياً وعاطفياً. توضحُ أن الكثيرين، يربطون الذوقَ الفنِّي بالرسمِ، أو الموسيقى فقط، لكنَّه أوسعُ من ذلك «فالفنُّ أداةٌ تربويَّةٌ عميقةٌ، تمنحُ الطفلَ مساحةً للتعبيرِ، والتعاملِ مع عواطفه، وتطويرِ مهاراتِ حلِّ المشكلات والتفكيرِ النقدي لديه». مضيفةً: «الحسُّ الفنِّي، هو قدرةُ الطفلِ على ملاحظةِ التفاصيل، ثم إعادةُ صياغتها بطريقته الخاصَّةِ سواء بالرسمِ، أو التشكيلِ، أو النحتِ، أو الموسيقى، أو حتى ببناءِ مجسَّمٍ من المكعَّبات». وحول لماذا يُعدُّ الحسُّ الفنِّي مهماً لنموِّ الدماغِ عند الطفل؟ تجيبُ المدرِّبة: «عندما يستعملُ الطفلُ عينَيه، ويدَيه، وخياله معاً، تتكوَّن في دماغه روابطُ عصبيَّةٌ أكثر. دماغُ الطفل، ينمو عبر ما يُسمَّى بالتشابك العصبي المتعدِّد أي عندما تتكوَّن فيه وصلاتٌ عصبيَّةٌ كثيرةٌ وجديدةٌ. حينما يتعرَّضُ الطفلُ للفنون، يُحفِّز ذلك الجزءَ الأمامي المسؤولَ عن الابتكار، كما تتعاونُ مراكزُ السمعِ والبصرِ مع مركزِ العاطفة. هذه الوصلاتُ، تجعلُ الدماغَ أكثر مرونةً، وتساعدُ الطفلَ لاحقاً على ضبطِ مشاعره وتنظيمها، وتكوين مهاراتٍ أساسيَّةٍ للنجاحِ الأكاديمي والاجتماعي». وتتابعُ كبَّارة: «يرتبطُ الإبداعُ بشكلٍ وثيقٍ بصحَّةِ الجهازِ العصبي. عندما ينمو الطفلُ في بيئةٍ آمنةٍ ومستقرِّةٍ، يشعرُ بالطمأنينةِ الجسديَّةِ والعاطفيَّة، ويكون دماغه في حالةِ تنظيمٍ، تُعرَفُ بالاستجابةِ الاجتماعيَّة حيث يَنشطُ العصبُ الحائر المسؤولُ عن التهدئة. في هذه الحالةِ، ينتقلُ الدماغُ من وضعيَّةِ الدفاعِ إلى وضعيَّةِ الاستكشاف، ما يفتحُ المجالَ أمام الإبداعِ والتعبير. أيضاً، قد ينشأ الإبداعُ في بيئاتٍ غير آمنةٍ فبعض الأطفال، يستخدمون الفنَّ بوصفه آليَّةَ بقاءٍ، فيرسمون، أو يبتكرون، ليُهدِّئوا عاصفةً داخليةً، أو يخلقوا عالماً أكثر أماناً من واقعهم. في هذه الحالة، يكون الإبداعُ وسيلةَ تنفيسٍ وتنظيمٍ، وليس بالضرورةِ تعبيراً عن الراحة. هنا تكمنُ قوَّةُ الفنِّ: فهو لا يزدهرُ فقط في الطمأنينة، بل ويستطيع أيضاً أن يُوفِّر شعوراً بالأمانِ في ظروفٍ خارجيَّةٍ مضطربةٍ. عليه، تسهمُ الرعايةُ الهادئةُ والمطمئنةُ من الأهل في تهيئةِ بيئةٍ صحيَّةٍ للإبداع، كما تخلقُ قاعدةً، تساعدُ الطفلَ على التعبيرِ بحريَّةٍ سواء كان ينطلقُ من الألمِ، أو من الأمان».
ما رأيك بالاطلاع على العائلة في خطر...التحولات الأسرية وآثارها المجتمعية
دور الأهل في تنمية الحس الفني
في عالمٍ سريعِ الإيقاع ومليءٍ بالشاشات، قد يبدو الحديثُ عن الفنِّ وكأنَّه أمرٌ ثانوي، لكنْ في الحقيقة، الحسُّ الفنِّي والإبداعي جزءٌ لا يتجزَّأ من بناءِ هويَّةِ الطفل ونموِّه الصحي. في هذا الجانبِ، تُؤكِّد المدرِّبةُ أهميَّةَ دورِ الأهلِ في تنميةِ الحسِّ الفنِّي لدى أولادهم، تقولُ: «ليس على الأهل أن يكونوا فنَّانين، أو متخصِّصين لفعلِ ذلك، فما يحتاجه الطفلُ فعلياً أن يشعرَ بأن خيالَه وأفكارَه وإبداعَه مرحَّبٌ بهم. الإبداعُ مهارةٌ حياتيَّةٌ تُكتَسب، ويستطيعُ الأهلُ دعمها منذ الصغرِ بأن يكونوا فضوليين مع أطفالهم، ومتفاعلين، وأن يسمحوا لهم بالاكتشافِ والتجريبِ عبر منحهم الفرصَ للعبِ المفتوحِ والحرِّ، والتجربةِ دون تصحيحٍ فوري أو خوفٍ، وطرحِ الأسئلةِ الغريبة دون أحكامٍ أو انتقادٍ، والتفاعلِ مع الطبيعةِ والعالم الخارجي، والمشاركةِ في الأنشطةِ الفنيَّةِ والثقافيَّة». وتستطردُ: «التربيةُ الواعية، تقومُ على قاعدةِ توازنٍ بين حدودٍ واضحةٍ نابعةٍ من القيمِ الأسريَّة، ومساحاتٍ حرَّةٍ للتجريب. نضعُ قاعدةً مثلاً أن الموادَّ الفنيَّة، تُرتَّب بعد كلِّ نشاطٍ، لكنَّنا لا نفرضُ على الطفلِ طريقةً واحدةً للتلوين. الحدودُ، تُشعِرُ الجهازَ العصبي بالأمان، والمساحةُ الحرَّة، تُطلِقُ طاقةَ المخيِّلة». وعن رؤيةِ بعض الأهلِ الفنونَ أقلَّ أهميَّةً من العلوم، توضحُ كبَّارة: «الفنون، تُنشِّطُ الدوائرَ نفسها التي يحتاجها الطالبُ لاستيعابِ الرياضياتِ والهندسة، خاصَّةً فيما يتعلَّقُ بالتنظيمِ المكاني، والتسلسلُ الزمني. الدراساتُ الحديثة، تُبيِّن أن الأطفالَ الذين يمارسون الفنَّ، يُظهرون أداءً أفضل في الرياضياتِ والقراءة. السببُ، هو أن الفنَّ، يُدرِّب الدماغَ على الملاحظةِ الدقيقة، وحلِّ المشكلاتِ بطريقةٍ مرنةٍ، وهما مهارتان أساسيَّتان لكلِّ مادةٍ».
التعامل مع طفل لا يبدي اهتماماً واضحاً بالفن
كلُّ طفلٍ فنَّانٌ، يرى الجمالَ في تفاصيلَ صغيرةٍ، ويُعبِّر بعفويَّةٍ لا تعرفُ القيود. المشكلةُ، هي كيف نُبقي الإبداعَ مضيئاً لديه في ظلِّ الضغوطِ الاجتماعيَّة، والانتقادِ، والتعليمِ الصارم، حسبَ كبَّارة. تضيفُ: «عندما لا يُظهِرُ الطفلُ اهتماماً واضحاً بالفنون، لا تكون الخطوةُ الأولى بدفعه، أو الضغطِ عليه لأداءِ نشاطاتٍ معيَّنةٍ، بل باستكشافِ ما يمنعه من الوصولِ إلى مساحةِ الإبداعِ والابتكار. قد تكون هناك عوائقُ عدة، تقفُ أمامَ شعوره بالأمانِ والتعبيرِ عن ذاته بحريَّةٍ، منها النقدُ المتكرِّر، أو المقارنةُ المستمرِّةُ مع الآخرين، أو الخوفُ من عدم إتقانِ العملِ بالشكل المتوقَّع، ما يُشعِرُ الطفلَ بعدمِ الثقة، ويدفعه إلى الانسحاب». وتشرحُ: «الهدفُ ليس الحصولَ على نتائجَ مثاليَّةٍ، وإنما الاستمتاعُ بالتجربةِ ذاتها، وبهذه الطريقة، نمنحُ الطفلَ فرصةً حقيقيَّةً للابتكار، ونغرسُ فيه الفضولَ والشجاعةَ للتعبيرِ عن ذاته من خلال الفنِّ، أو أي وسيلةٍ إبداعيَّةٍ أخرى». وتُشدِّد المدرِّبةُ على أهميَّةِ زيارةِ المتاحفِ والفعاليَّات الثقافيَّةِ بانتظامٍ، إذ «تُقدَّم زيارةُ المتحفِ بطريقةٍ ممتعةٍ ومبسَّطةٍ، وتتحوَّلُ إلى وقتٍ نوعي للعائلة للتعرُّفِ على أصواتِ الحضاراتِ والثقافاتِ المتعدِّدة، والفنونِ والإبداعاتِ عبر العصور، ما يُتيح للطفلِ فرصةَ ربطِ الماضي بالحاضر، وتعلُّم مهاراتِ الملاحظةِ والتحليل وطرحِ الأسئلة، وهي أساسيَّاتٌ في التفكيرِ الإبداعي. كذلك يُوسِّع ذلك أفقه، ويُغذِّي فكره، ويزرعُ داخله احتراماً للتنوُّع، ويُشعِرُه بأنَّ له مكاناً في مجتمعٍ أكبر من أسرته، ويُرسِّخ لديه قيماً عائليةً مهمَّةً مثل الانتماءِ، وحبِّ العلم، والثقافة». وحول علاقةِ الزياراتِ المتحفيَّةِ بالذاكرةِ السرديَّةِ للأسرةِ العربيَّةِ تحديداً، تردُّ كبَّارة: «المتحفُ يشبه كتاباً حياً. الطفلُ، يرى القطع، ويسمعُ قصَّتها في اللحظةِ نفسها، ما يُنشِّط لديه الجزءَ المسؤولَ عن الذاكرةِ البصريَّة، والجزءَ المسؤولَ عن المعاني معاً، فيتكوَّن تعلُّمٌ أعمقُ، يستمرُّ طويلاً. إضافةً إلى ذلك، المتحفُ يُوفِّر تجربةً حسيَّةً شاملةً، تتقاطعُ فيها المادةُ التاريخيَّة مع الحكايةِ المجتمعيَّة، والأدواتِ البصريَّةِ والحسيَّة. عندما يرافقه الوالدان، ويتبادلان معه التأمُّلَ والسؤال، يتحوَّلُ الحدثُ إلى ذكرى عائليَّةٍ مشتركةٍ، تُثبِّت الإرثَ الثقافي في وعيه، وتدعمُ هويَّته وقيمه». وتزيدُ: «يمكن للأهلِ تحويلُ الزياراتِ المتحفيَّةِ إلى وقتٍ نوعي منتظمٍ حين ينظرون إليها بوصفها جزءاً ثابتاً من أسلوبِ حياتهم العائلي، وليس نشاطاً ترفيهياً عابراً. يضعُ الوالدان هدفاً مصغَّراً لكلِّ زيارةٍ، كأن يبحث الجميعُ عن لوحةٍ، يطغى عليها لونٌ معيَّنٌ، أو عن قطعةٍ من عصرٍ محدَّدٍ، فيصبح التجوالُ أشبه بلعبةِ استكشافٍ ممتعةٍ. قبل الانطلاق، يُمهِّد الأهلُ للزيارةِ عبر حوارٍ دافئ، يُحفِّز خيالَ الطفل، ويُشعِرُه بالفضول، وأثناء الجولة، يتولّون دورَ الميسِّر لا المُلقِّن، فيطرحون أسئلةً مفتوحةً مثل: ماذا ترى. بدلاً من إلقاءِ المعلوماتِ الجاهزة، فيُنشِّطون بذلك دماغَ الطفل، ويُعلِّمونه التفكيرَ والتحليل. وبعد العودةِ إلى البيت، يمكن أن يمتدَّ أثرُ الزيارةِ عبر إعادةِ سردِ تجربة الطفلِ بالرسم، أو اللعبِ التمثيلي، أو تدوين يوميَّاتٍ قصيرةٍ، ما يُثبِّت المعرفةَ في الذاكرةِ طويلةِ الأمد، ويُعمِّق شعورَه بالإنجاز. ومع التكرار، يصبح المتحفُ تقليداً ثقافياً عائلياً، يُرسِّخ القيمَ المشتركة، ويربطُ المتعةَ بالتعلُّم، ويمنحُ الأهلَ فرصةَ مراقبةِ نموِّ أبنائهم الفكري والعاطفي عبر محطَّاتٍ منتظمةٍ من الحوارِ والتأمُّلِ المشترك».
يمكنك أيضًا الاطلاع على الحِرف اليدوية ملاذ لتصفية الذهن ووسيلة للشفاء النفسي
دور المدرسة في تنمية الحس الفني وحفظ الذاكرة الجماعية
المدرسةُ شريكٌ أساسٌ للأسرةِ في تنميةِ الحسِّ الفنِّي للطفل، كما تُؤكِّد كبَّارة، وتُحدِّد دورها بالقول: «عندما تُدرَج الفنون في المنهجِ سواء عبر حصصِ الرسم، والموسيقى، أو من خلال مشروعاتٍ عن التراثِ المحلي والعالمي، يحصلُ الطفلُ على تدريبٍ منتظمٍ، يُكمِّل ما يراه في البيتِ والمتحف. كذلك، تتيحُ المدارسُ رحلاتٍ ميدانيَّةً إلى المتاحفِ والمواقعِ الأثريَّة، فتربطُ بذلك المعرفةَ الصفيَّةَ بالتجربةِ الحيَّة. والأهمُّ أن المعلِّم حين يُشجِّع على الأسئلةِ المفتوحة، ويحتفي بالتنوُّعِ الثقافي داخل الصف، يُعلِّم الأطفالَ احترامَ رواياتِ الآخرين وأدوارَهم في الذاكرةِ الجماعيَّة». وتختتمُ المدرِّبةُ حديثها: «إن على الأهلِ مدَّ الجسورِ مع المدرسةِ عبر متابعةِ نشراتِ الأنشطةِ المنهجيَّة واللامنهجيَّة، واقتراحِ ورشِ عملٍ فنيَّةٍ، وحضورِ معارضِ الطلبة. هذا التواصلُ، يخلقُ حلقةَ دعمٍ متكاملةً بين البيتِ والمدرسةِ والمجتمع».
يمكنك متابعة الموضوع على نسخة سيدتي الديجيتال من خلال هذا الرابط